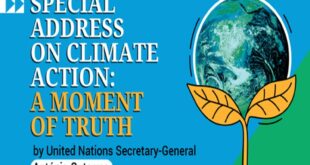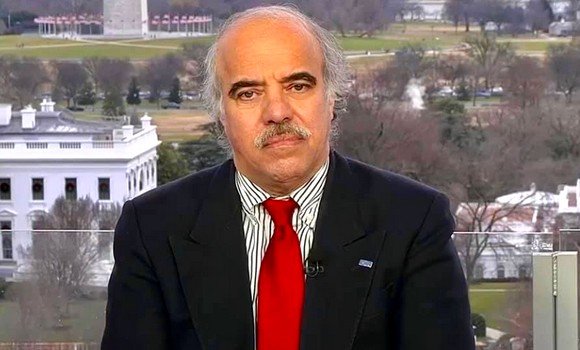
هي دلالاتٌ متعدّدةٌ امتزج فيها الإنسانيُّ والدّينيُ والرّوحانيُ والرّمزيُ والنّقديُ لدى المغاربة في تأويلهم محنة الطفل ريّان أورام في البئر. وينقسمون في ذلك بين فكرتيْ “المجد المختار” و”الصدمة المختارة”. وفي ثنايا الخطاب العام والأدعية والتطوّع للحفر من أجل إنقاذ حياة ريان والتبرّع لأسرته، تبرزُ عدّة أسئلة مثيرة:
كيف غلب الانتماءُ الجماعي على الهوية الفردية ضمن “تمغرابيت” كناية عن الهوية الوطنية الجامعة، وما علاقة هذا التحوّل بالشعور الوطني ومستوى التّضامن معه وأسرته؟ وثمّة من بشّر بـ”تجدّد” الأمة المغربية، فيما تمسّك بعضهم بالعودة إلى المقدّس واعتبار المشهد “لحظة ربّانية”. ويعتقد آخرون أنه كان من الممكن إسعاف الطفل في الساعات الثماني والأربعين الأولى، لو اختلفت خطّة الحفر باستخدام معدّات متطوّرة والاستعانة بخبرات أجنبية.
عند تقاطع ما هو روحانيٌ وما هو عقلانيٌ في فهم المأساة، تتعدّد نظرياتُ علم النفس الاجتماعي في تفسير الحالة النفسية والذهنية لأفراد المجموعة البشرية خلال أوقات الفواجع والكوارث أو البطولات والانتصارات. وتتباين في تطوّرها ودلالتها على مرّ أكثر من قرن، بداية بسيغموند فرويد وسابقيه نهاية القرن التاسع عشر، ونهاية بالجديد في علم النفس السياسي وبقية المنطلقات المعاصرة، ومن أحدثها نظرية تحديد المواقع (Positioning theory)، والتي بلورها برونوين ديفيز، وروم هاري، ولوك فان لانجينهوف، منذ منتصف التسعينيات، بناء على اجتهادات ليڤ فيگًوتسكي. وتهتم هذه النظرية بتفكيك الأدوار المرنة والسرديات التي نتعامل بها، وحدود الأفعال والمواقف المرتقبة في المستقبل، ومعاني ما نقوله وما نفعله في ظلّ ثنائية الحقوق والواجبات التي نسند بها تلك السرديات من منظور معياري وفي سياق الثقافة والقيم المتداولة داخل المجتمع.
.. الآن، وقد تمّ دفن جثمان ريان، تبرز مفارقة مثيرة في تفسيرات المغاربة لطبيعة المأساة وطريقة التعامل معها، وكيف تمثل “مجدا مُختارا” كتجسيد للروح المغربية لدى بعضهم، أو أنها “صدمة مُختارة” لدى آخرين، إذا اعتمدنا مفاهيم فاميك فولكن، أحد أهم علماء النفس الاجتماعي ومؤسّس مركز دراسات العقل والتفاعل البشري في كلّية الطب بجامعة فرجينيا الأميركية.
تحوّل الرّاحل ريان إلى “شهيد”، و”ملاك” أقام بيننا قليلا
يعتقد الفريق الأوّل أنّ السّلطات المغربية قامت بكلّ ما كان يمكن أن تقوم به، وأنّ الخبرات المحلية والتقنيات والمعدات بذلت قصارى جهودها على قدم وساق من أجل إنقاذ ريان. ويعتزّ كثيرون بفريق الحفر، ومنهم سي علي الصحراوي، المتمرّس في حفر الآبار بالطريقة التقليدية. وهذه أمورٌ يمتزج فيها الإيثارُ وروحُ التضحية ورمزياتٌ أخلاقيةٌ أخرى، وتساهم في رواج سردية الفخر بروح “تمغرابيت”، وأن المغاربة “أزاحوا جبلا” من أجل الوصول إلى الطفل المحاصر تحت الأرض.
يعتقد هؤلاء أنّ تلك الأيام العصيبة كانت بمثابة “ملحمة” وحّدت المغاربة، وحشدت إليهم تقدير الرأي العام الدولي. ويذهب بعضهم إلى أنها بلورت تجديدا في اللحمة الوطنية، بل واستثناءً آخر ضمن السردية الكبرى بشأن “الاستثناء المغربي”، أو هندسة “المجد المختار” وفق خلاصة فولكن. ويقول السفير المغربي، حسن طارق، إن ما حدث ” كان، بلا مبالغات في اللغة، تعريفا آخر للأمّة المغربية. الأمّةُ كشراكَةِ أحلامٍ وأحزانٍ، الأمّةُ كقدرٍ يَصْهِر مصائر موّحِّدَةٍ، الأمّةُ كـ”نَحْنٌ” من المشاعر والذكريات والرموز والآلام والانتصارات”.
قد تساهم هذه السّرديات وغيرها في إنعاش المشترك المتخيّل تحت مظلّة الدولة الأمة، ضمن نسق البنائية الاجتماعية، وأننا نتخيل أنفسنا نعيش في مجتمع متجانِسٍ ومتّسِقٍ بفعل التاريخ واللغة والدين والهوية وبقية المشترك الاجتماعي، كما أوضح بينديكت أندرسون في كتابه “المجتمعات المتخيَّلَة”. غير أنّ التلويح بإعادة تعريف الأمة أو تجدّد هويتها خلال المآسي يتهوّر بمجازفتيْن مهمتيْن: أوّلهما، يتجاهل ما إذا كان تجديد الأمّة ومزاجها الجماعي يحتاج، في المقابل، انتصارات وإنجازات كبرى أيضا، ولماذا لا يقدّم قرينة موازية، وكأنّ الأحزان أشدُّ وقعا وأعمقُ تأثيرا من الأفراح في انتعاش الانتماء الجماعي للدولة. وهذه فرضيةٌ تستمدّ منطقها التبسيطي من قولة نيتشه: “كيف يمكنك أن تغدو جديدا إنْ لم تتحوّل أوّلا إلى رماد”!
كلّما زاد الفخر والتباهي برمزية المأساة، يشعر أفراد المجتمع بأنّه “يحقّ لهم” فعل أيّ شيء للحفاظ على هويتهم
ثانيهما، القفز على طبيعة الحمولة النفسية الجماعية بفعل الصدمة وتداعياتها على القلوب والمعنويات والتصرّفات. ويلاحظ الدكتور فولكن أنّ أفراد المجتمع يصبحون في حالة انحسار أو نكوص نفساني (psychological regression) خلال تعلّقهم بالمجد المختار أو الصدمة المختارة. وتظهر على تفكيرهم وتصرّفاتهم عشرون من الأعراض، منها فقدانُ الإحساس بفردانيتهم أو هويتهم الفردية، ما يجعل تمغاربيت وبقية تجليات الروح الوطنية رصيدا أو قيمة مجتمعية حيوية، وهي أيضا ما نفخت روحا جديدة في مبادرات الإيثار والتبرّع والتطوّع والمثابرة بين فريق الحفر وبقية المتعاطفين، سواء في الميدان أو عبر الشاشات.

وقد لجأ أغلب المغاربة إلى “آليات الحدس والإسقاط” بشكل واسع النطاق في تفسيرهم ما حدث، كما يلاحظ فولكن، فتجدّدت لديهم مرجعية الدّين، واعتبر بعضهم الأيّام الخمسة العصيبة “لحظة ربّانية”، ووظّفوها في الترغيب في الصلاة والتنبيه بفزّاعة “عذاب القبر”، وتحوّل الرّاحل ريان إلى “شهيد”، وأنّه كان “ملاكا” أقام بيننا قليلا. وتعمّدت قنوات غير احترافية لغةً دراميةً واهيةً تنمّ عن التشويق بتكرار عدد الأمتار المتبقية في الحفر، وصناعة الأسطورة، وما لامس “جذبة روحانية” في تكريس ما اعتقدوا أنّه وطنية مغربية متوهجة. وهذه نزعةٌ مرتقبةٌ عندما يبدأ أفراد المجموعة البشرية في تجربة الرّموز المشتركة على أنّها “رموز أوّلية”، وأنهم يعايشون “مرحلة الاعتقاد الأسطوري وضبابية صورة الواقع”، كما يوضّح الدكتور فولكن.
كلّما زاد الفخر والتباهي برمزية المأساة، يشعر أفراد المجتمع بأنّه “يحقّ لهم” فعل أيّ شيء للحفاظ على هويتهم، وينخرطون في سلوكات “ترمز إلى الطهرانية ونقاء الذات”. ويمرّون أيضا بتقلباتٍ مزاجيةٍ تصاحبها مشاعر اكتئاب مشتركة، وأحيانا الاعتدادُ “بالروح القومية أو بجنون العظمة الجماعية”، فيما تصبح الأخلاق والمعتقدات المشتركة “استبداديةً وعقابيةً تجاه أولئك الذين يُعتقد أنهم يتعارضون معها”، حسب تعبير فولكن.
يعتقد بعضهم أنّ تلك الأيام العصيبة كانت بمثابة “ملحمة” وحّدت المغاربة، وحشدت إليهم تقدير الرأي العام الدولي
يعتقد الفريق الثاني أنّ إنقاذ ريّان كان يتطلب خطة استراتيجية مغايرة، ويميل إلى ضرورة عقلنة السبل والنتائج في تقييم الفاجعة وسط تواتر حالات معاناةٍ سابقة، خصوصا بفعل تداعيات الحجر الصحي، وأمْنَنَة مرحلة كورونا، وتدهور الأوضاع المعيشية، وإغلاق المطارات، وخيبات الأمل عقب الهزيمة في منافستي كأس أفريقيا للأمم وكأس العرب وغيرها من التعثرات. ويقترح هؤلاء تقييم دور الوقاية المدنية وما ينقصها من خبرات ومعدّات. وقد عزا مستشار وزير التجهيز والماء في الحكومة المغربية، أحمد بخري، الفشل في إنقاذ الطفل إلى “غياب المراكز الجهوية المتوفرة على آليات الإنقاذ المتطوّرة، ومحدودية الآليات التي تم استعمالها، والتي لا تتجاوز قدرتها حفر 20 مترا في اليوم، وصعوبة وصول آليات بقدرة حفر أكبر تصل إلى مائة متر في اليوم”، وخلص إلى أنه كان بالإمكان النجاح في إنقاذ الطفل في أقل من 48 ساعة.
قد يكون من الصعب على بعضهم تقبّل الطرح التقريظي الصريح أو مساءلة الذات، وقد يدفعون بالتسليم بحكم الأقدار ودفن الفتى الفقيد وانتهى الكلام. لكن تجدّد روح الأمّة في جوهره يقتضي أخذ العِبَر وتصحيح ما لا ينفع من ممارسات تقليدية، وكسب الرّهان وتجاوز التحدّيات. وكما قال أنشتاين ذات يوم: “مشكلتُنا الكبرى هي مثاليةُ الوسيلة وغموضُ الغايات.. وأنّ الحقيقة هي ما يَثْبُت أمام إمتحان التجربة”.
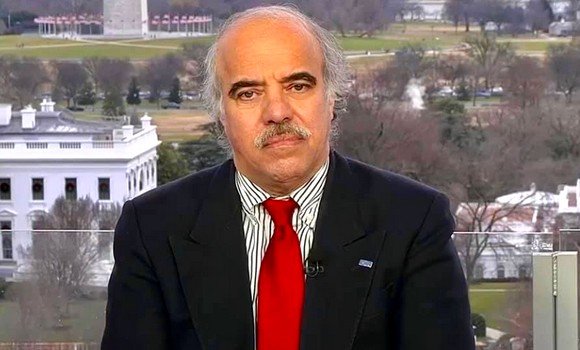
محمد الشرقاوي – أكاديمي وكاتب المغربي / العربي الجديد




 ميادين | Mayadin مرآة المجتمع، ملفات، تحليلات، آراء وافكار و رسائل لصناع القرار.. صوت من لا صوت له | الإعلام البديل
ميادين | Mayadin مرآة المجتمع، ملفات، تحليلات، آراء وافكار و رسائل لصناع القرار.. صوت من لا صوت له | الإعلام البديل